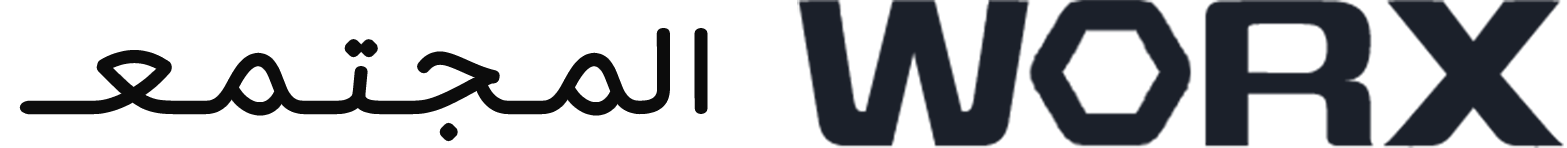متلازمة البطل: حين تتحول الرغبة في النجدة إلى هوس بالإثبات والظهور
- 17 أبريل, 2025
- 17 دقائق للقراءة
في عالم يمجد الإنجاز، ويعلي من شأن المبادرة الفردية، ويمنح الأضواء لمن يتقدم الصفوف، يتسلل إلى بعض النفوس دافعٌ داخلي للعب دور البطل، لا حبًا في الخير، بل شوقًا للظهور. هذه الحالة التي تُعرف في علم النفس بـ"متلازمة البطل" (Hero Syndrome)، تضعنا أمام إشكالية نفسية واجتماعية في آن: كيف يمكن للرغبة في المساعدة أن تصبح عبئًا؟ ومتى ينقلب السعي للتميز إلى محاولة قهرية لإثبات الذات على حساب الآخرين؟
تعريف متلازمة البطل
متلازمة البطل هي حالة نفسية يشعر فيها الشخص بدافع مستمر للقيام بدور المنقذ أو المخلّص، ويبحث دائمًا عن مواقف يمكنه فيها أن يثبت "بطولته" أو تفوقه، حتى إن لم تكن هناك حاجة حقيقية لتدخله. قد يقدم النصيحة دون طلب، يتدخل في شؤون الآخرين، يحرص على التواجد في كل الأزمات، بل وربما يفتعل مواقف درامية ليبرر وجوده كبطل.
ورغم أن السلوك الظاهري قد يبدو إيجابيًا، بل بطوليًا في نظر البعض، فإن دوافعه الخفية لا تكون نقيّة دائمًا. فغالبًا ما يكون المحرك الرئيس لهذا السلوك هو رغبة عميقة في إثبات الذات، وتعويض مشاعر النقص، وليس بدافع الإيثار الحقيقي أو العطاء النقي.
البُعد النفسي: جذر الشعور بعدم الكفاية
لفهم متلازمة البطل، لا بد من الغوص في أعماق النفس البشرية. فغالبًا ما يرتبط هذا السلوك بأشخاص يعانون من شعور داخلي بعدم الكفاية، أو يفتقرون إلى التقدير الذاتي، فيسعون إلى سد هذا الفراغ عبر لعب دور المنقذ. هم يرون في كل مشكلة فرصة للتدخل، وفي كل أزمة مناسبة لإظهار الشجاعة، لأنهم يجدون في هذه المواقف قيمة لذواتهم، التي لا يرونها ذات معنى إلا حين يشعرون بأنهم "المنقذون".
كما يمكن أن تكون الجذور قديمة، تعود إلى الطفولة، حين كان الطفل لا يُشعر بقيمته إلا عندما "يفعل شيئًا خارقًا" يثير إعجاب الوالدين أو المعلمين. هذا النموذج من التربية قد يغرس في الفرد قناعة بأن قيمته مرتبطة بالإنجازات الخارقة، لا بمجرد وجوده كإنسان يستحق الحب والتقدير.
متلازمة البطل في بيئة العمل: بطولة مزعجة
في المؤسسات والشركات، قد يظهر هذا النمط من خلال الموظف الذي يتدخل في كل صغيرة وكبيرة، لا يكتفي بمهامه بل يتجاوزها ليتدخل في مهام زملائه، يصرّ على اقتراح الحلول دون أن يُطلب منه، بل ويتحدث باسم الفريق في الاجتماعات وكأنه الناطق الرسمي باسم الإنجاز.
قد يظن المديرون في البداية أنه موظف مثالي، نشيط، مبادر. لكن مع مرور الوقت، تتكشف الأبعاد المزعجة لسلوكه. فهو لا يتردد في تهميش دور زملائه، وينسب النجاح لنفسه، ويقوّض روح الفريق. وهنا يصبح تدخله أشبه بتعدٍّ، وسلوكه مصدرًا للتوتر وانعدام الثقة.
متلازمة البطل في العلاقات الشخصية
لا يقتصر هذا الاضطراب على بيئة العمل. بل يتجلى أيضًا في العلاقات الأسرية والاجتماعية. فقد يكون هناك صديق أو شريك أو قريب يسعى دائمًا لأن يكون "المنقذ"، يتدخل في حياة الآخرين، يقرر عوضًا عنهم، يُشعرهم بأنهم ضعفاء أو غير قادرين على تدبير شؤونهم، ويأخذ قراراتهم على عاتقه "لأنه يعرف مصلحتهم أكثر منهم".
هذا النوع من السلوك، وإن بدا في ظاهره حرصًا واهتمامًا، فإنه في حقيقته يحمل نوعًا من السيطرة المقنّعة، ويؤدي إلى إضعاف الطرف الآخر، بل وحرمانه من النمو والاستقلالية. كما قد يخلق شعورًا بالكبت، وكأن الشخص يعيش في ظل "بطل" لا يترك له مساحة لاتخاذ القرار أو حتى ارتكاب الخطأ.
الثقافة والمجتمع: دور بيئتنا في تعزيز المتلازمة
المجتمعات التي تمجّد الفرد المتفوق، وتربط القيمة الشخصية بالإنجازات الفذة، قد تساهم بشكل غير مباشر في تعزيز متلازمة البطل. حين يرى الشخص أن الإعجاب والحب والتقدير لا يُمنح إلا لأصحاب "القصص العظيمة"، يبدأ بالسعي لخلق تلك القصص، ولو من اللاشيء. بل وقد يجد في الإعلام أو السينما ما يدعم هذا التوجه، حيث يتم تصوير "البطل" على أنه الشخص الذي يُنقذ الجميع، بينما يُنظر إلى الهادئين، الداعمين، المتواضعين، على أنهم أقل بريقًا.
التأثير على من حوله
من يعيش بجوار من يعاني من متلازمة البطل، يجد نفسه في حالة من الإرباك أو الانزعاج الدائم. فهو أمام شخص لا يتوقف عن التدخل، لا يثق بقدراته، ينتزع منه المبادرة، وقد يُشعره – بشكل غير مباشر – بأنه دائمًا في حاجة للمساعدة، حتى لو لم يكن كذلك. وهذا قد يؤدي إلى اهتزاز الثقة بالنفس، أو شعور بالاحتقار الذاتي، خاصة إذا تم تهميش جهوده أو سلبه الفضل أمام الآخرين.
كيف نتعامل مع متلازمة البطل؟
التعامل مع هذا النمط السلوكي يحتاج إلى وعي وحكمة، سواء من الشخص ذاته أو من المحيطين به. أولًا، على الشخص أن يدرك أنه ليس من الضروري أن يكون بطلًا دائمًا ليكون شخصًا ذا قيمة. الحياة لا تحتاج دومًا إلى منقذ، بل أحيانًا يكفي أن تكون حاضرًا، داعمًا، متفهمًا.
أما من يعيشون مع شخص يعاني من هذه المتلازمة، فعليهم وضع حدود واضحة، وممارسة الصراحة بطريقة غير هجومية. من المهم تعزيز فكرة العمل الجماعي، وتوزيع الأدوار بعدالة، وتذكير "البطل" بأن التدخل المستمر قد يكون مؤذيًا، حتى لو كان بنية حسنة.
العلاج النفسي: إعادة بناء الذات
في الحالات الأكثر وضوحًا وتأثيرًا، قد يكون العلاج النفسي السلوكي وسيلة فعّالة لمساعدة الشخص على فهم دوافعه الداخلية، وإعادة النظر في صورته الذاتية، والتصالح مع فكرة أنه يستحق التقدير لمجرد كونه هو، لا فقط حين ينقذ الآخرين. كما يساعده العلاج على تنمية مهارات الإنصات، والتواضع، والتعاون، والتخلّي عن الحاجة القهرية للظهور.
خاتمة: لا بأس ألا تكون البطل
في النهاية، لا بأس ألا نكون الأبطال في كل قصة. بل لعل البطولة الحقيقية تكمن في منح الآخرين المساحة ليكبروا، في تمكين من حولنا لا تقييدهم، في المساهمة الصامتة التي لا تنتظر التصفيق، وفي بناء بيئات تشاركية لا يهيمن فيها فرد على الجميع. لنعِد النظر في دوافعنا، ونسأل أنفسنا: هل نساعد حقًا؟ أم نبحث عن اعتراف؟ الإجابة الصادقة قد تكون أول خطوة نحو التوازن.
محادثة
0 تعليقاتمرحبًا بك في منطقة التعليقات! كن مهذبًا وابقَ في صلب الموضوع. قم بزيارة الشروط والأحكام الخاصة بنا واستمتع معنا!
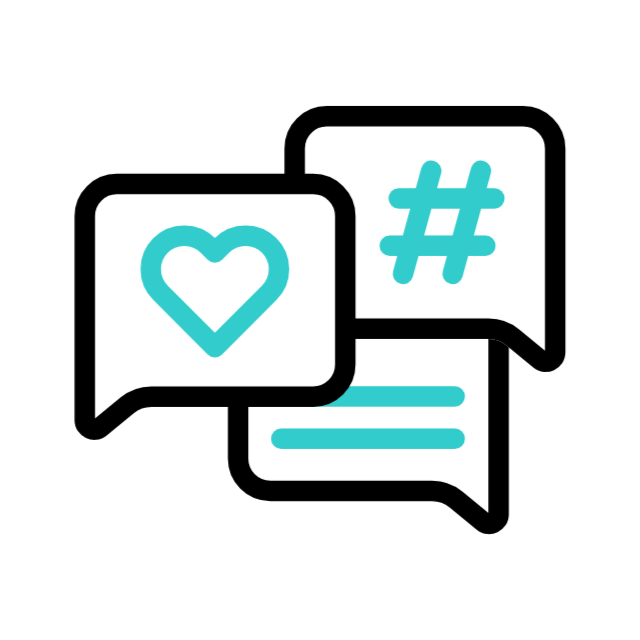
لم يتم إضافة أي تعليقات بعد، كن الأول وابدأ المحادثة!